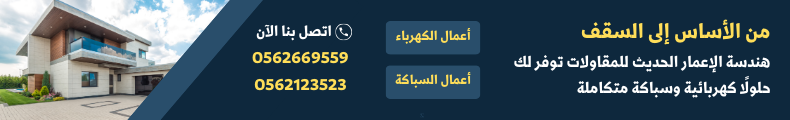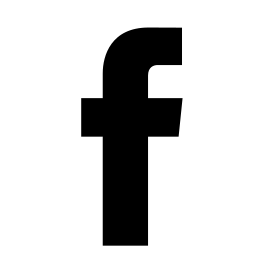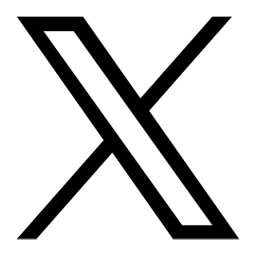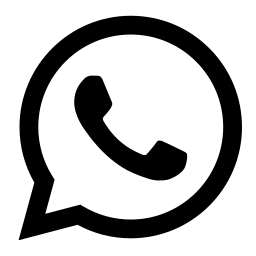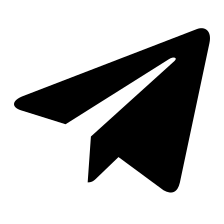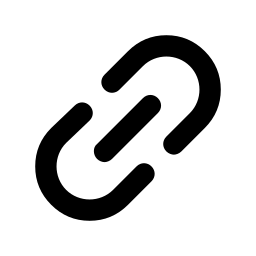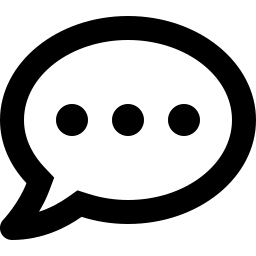الناقدُ.. العقلُ الاستراتِيجي للإبدَاع
تنتمي العلاقةُ بين الناقد والشاعر إلى نوعيَّة العلاقات التعاونية لا التنافسيَّة، إذ كل واحد منهما يُكمل الآخر ويساعده في أداءِ رسالته، فكما يهتمُّ المبدع بالأداء والجودة والاختيار المتقن، يدفعُ الناقد إلى تحديدِ الأطُر وإقامة القوانين اللازمة وإيقافِ الاتجاه ناحية أخرى ليست مُستساغة وتؤدِّي إلى ضرر في اللغة أو الثقافة أو المجتمعِ أو نحو ذلك، وهذهِ العلاقة لم تبدأ مُنذ اليوم وإنما معَ ظهورهما معا، حيث كلُّ مبدع رافقه ناقد، إمَّا في داخله أو خارجه، لأن المبدعَ أيضاً يحمل النقدُ في داخله بفعل الممارسة المستمرَّة للإبداع؛ ما يمكِّنه من إصدار الآراء والتوجيهاتِ وإعطاء النصائحِ والتلميحات، ولهذا يتمُّ الرجوع إليه والاستِمَاع لرأيه بل والأخذ به؛ لقربه الشَّديد من التجربةِ الإبداعية، لكنَّه رغم ذلك لا يلغي الناقدَ الذي سيستمرُّ في الظهورِ والمشاركة، وهو ما تبدَّى عبر مراحل التاريخِ المختلفة.
تزدحمُ كتُب التراث بحوادث الشعراء والنُّقاد، ولعل أشهرها ما تعلَّق بالنابغة الذي كانت تُضرب له خيمة من جلد أحمرَ في سوق عكاظ؛ أحدِ أشهر أسواق العربِ في الجاهلية، إذ كان يجلسُ ويأتيه الشعراء يعرِضون أشعارهم كي يقيِّمها ويحكم بالجودة أو الرداءةِ عليها مقارنةً بأشعار غيرهم، وهو ما استمرَّ زمناً مديداً حتى استقرَّ في وجدان الناس بضرورة وجودِ ناقد للشعر عالمٍ به، سواءً أكان من داخله كما هو حالُ النابغة أمْ من خارجه كما هو حالُ آخرين وأُخريات، مثل زوجةِ امرئ القيس التي فاضلت بين شعرِ زوجها وشعر شاعرٍ آخر، وحكمت على شعرِ زوجها بأنه أقلَّ من شعر الشاعرِ الآخر.
الحالةُ النقدية في العصر الجاهلي لم تتعدَّ الأحكام الذَّوقية التفضيليَّة ما بين شاعر هو أفضلُ الشعراء وقول هو خيرُ ما قيل، وهذا ما يُلمس في الموروثِ الإسلامي اللاحقِ للجاهلية وعلى لسانِ النبي الكريم بنفسه، حينما وصفَ قول لبيد ”ألا كلُّ شيء ما خلا اللهَ باطل“ بأنَّه أصدقُ كلمة قالتها العرب، والمعيارُ هنا ليس في الجودة والرداءة بل في الصِّدق والكذب الحقيقي، فما يهمُّ النبي ليس الفنَّ كفن باعتباراته الجمالية والبلاغية والإبلاغية، إنما التَّعبير الصَّادق عن المعتقدات الدينية والشرعية المتوافقةِ مع التعاليم التوحيديَّة التي جاء بها، ولهذا لا يمكن اتِّخاذ رأي النبي نقداً للشعر، كما لا يمكن عدُّه ناقداً كذلك لتلبُّس النقد بالشِّعر وممازجته له، وهو ما نفتهُ عنه الآية الكريمة ﴿وما علَّمناه الشِّعر وما ينبغِي له﴾ .
كما ابتعدَ النبي عن كونه ناقداً للشعر كذلك ابتعدَ خلفاؤه الكرامُ عن مقاربةِ الأشعار والإدلاء بدلوهم فيها، فالحالةُ الدينية والشرعيَّة اقتضت منهم اتِّباع السنة وسُلوك الطريقة التي سارَ عليها، ولهذا كانوا يعودونَ في المشكلات بين الشعراء والناس إلى أهلِ الاختصاص وهم المبدعُون أنفسهم، فالزبرقان بن بدر اشتكَى إلى الخليفةِ عمر بن الخطاب هِجاء الشاعر الحطيئة له، فما كانَ من الخليفة إلا أن استدعى حسَّان بن ثابت واستشارهُ في الأمر، حيث أكَّد أنه أقذَع في هجائه وبالغ في قوله، الأمرُ الذي جعل الخليفة يأمرُ بحبسه، وبقية القصة تتحدَّث عن استعطاف الحطيئة بأبنائه الجوعَى؛ ما جعلَ الخليفة يرقُّ لحاله ويطلق سراحَه.
لم يكُن حسان بن ثابت في حاجةٍ للإتيان بدليل على المبالغةِ في الهجاء الذي مارسَه الحطيئة ضد الزبرقان، لأنه لن يكذِب في حضرة الخليفةِ كما لن يُحابي على حسابِ الشعر والإبداع، ولهذا تمَّ الاستماع لكلامه ونقدِه وإن لم يدخُل في باب التحليل والبيان التَّام، وهو ما سيعمدُ إليه شعراء العصور التالية الذين لم يكتفوا بالكلماتِ المقتضبة والقليلة في حقِّ المبدعين، إذ اتجهوا إلى تحليلِ إبداعاتهم والكشف عن طُرُقهم وبيان مواضع جودتهم وإساءَتهم؛ حيث الهدفُ لم يعد المفاضلة بين شاعرين مبدعَين فحسب، لكونها اتِّجهت ناحية التعليمِ البلاغي والدرس الأسلوبي من أجل ترسِيخه في نفوس المتعلمين، وهو ما أدَّى إلى اختلاف المقاربةِ الجديدة للشعرِ عن سابقاتها، فلم تعُد مجرد العبارات التفضيليَّة أو العبارات الحاطَّة من القيمة تكفي المتعلِّمين والمتابعين، إذ لا بدَّ أن يرافقها بيانُ السبب الذي أدَّى إلى إطلاق الحكم.
تطوُّرات الحضارةِ الإسلامية وانتشارُ الثقافة العربية وبلوغُها مرتبة عاليةً في العصور التالية لعصرِ الرسالة أدَّى إلى الاهتمام الشديد بها، فهي لُغة القرآن والدين وعلى المسلم تعلُّمها من أجلِ ممارسة شعائره وفُروضِه كالصلاة والحج، لهذا تداخلَت الثقافات المتنوِّعة في الحديث عن جودتها وميزاتها ومحاولةِ اكتشاف أسباب عظمتِها وتحدِّي الله سبحانه لأهلها بأنْ يأتوا بآيةٍ من مثلِ القرآن النازل بها، وهو ما عجزوا عنه فاتَّجهوا إلى الكشف عن أسرارِ بلاغته ودلائلِ إعجازه، ما قادهم إلى بيان الجماليات التي احتوَى عليها والأساليب الرفيعةِ التي جاءَت في داخله، وهو الأمرُ الذي أثَّر في اللغويين الكبار المهتمِّين بالشعر والإبداع فساروا على نهجِه وكتبوا مثلَ أساليبِه.
اللغويون والبلاغِيون أخذوا في الظهورِ تباعاً وفي أزمنة متقاربة؛ نتيجةَ الانفتاحِ الثقافي على شعوب وأمم الأرضِ التي اندمجت معَ الحضارة الإسلاميَّة وتأثرَّت بلسان العرب، لهذا لم يكُن أمامهم إلا اتِّخاذ الصِّيغ التعليمية للبلاغةِ والبيانِ والكلامِ الفصيح، وهو ما حدث تلقائيًّا في البداية مع الشعراء والخُطباء والقصَّاصين، الذين اتَّجهوا إلى المحافظة على لغتِهم والعنايةِ بها واختيار الأساليب العاليةِ والكلمات الجزِلة والعبارات المؤثِّرة، وهيَ مما كان مفهوماً لدى عامة الناس في ذلكَ الزمان، لكن تداخُل الألسنة وعدم خُلوص العربية لأهلها جعلَ كثيراً منها غير واضِح، وهنا تمَّ اللجوء إلى جمع اللغة من أجل حِفظها من الاندثار والضَّياع، فظهر أمثالُ الأصمعي وأبي عمرو بن العلاء وحماد الراوية، الذينَ أخذوا يجوبون الصحراءَ ويلتقون أهلَها ويأخذون اللغة من أفواهِهم مُباشرة.
منبعُ اللغة وأصلها موجودٌ في لسان أعرابِ البادية الذين لم يختلطوا بعدُ بالحضارة واللسانِ الأعجمي، والرِّحلة إليهم كانت مشقَّة بالغة احتملها الرُّواة واللغويون؛ من أجل جمعِ اللغة والحفاظ على نقائِها وعدم ممازجتِها للخليط المنتشر من العربية وغيرِها، ونتيجةَ الجمع أدَّت إلى ظهورِ عددٍ من الكتب والتدوينات الثقافية؛ احتوَت على كلامِ العرب شعراً ونثراً، وأُودعت هذه الكتب لدى الورَّاقين فنسخوها وتداولها الناس، وهنا ابتدأَت الحركة البلاغية بالصُّعود، فكلامُ العرب بات مدوناً ويمكن الاستفادةُ منه في المقارنةِ والبحث والتحليل، وهو ما قامَت به مجموعاتٌ من اللغويين والنحاةِ الذين استخرجوا مُختلَف الأساليب والتراكيب، وعمِلوا على تصنيفها وتبويبها وتقسيمِها، ثم فرَّقوا بينها وبين غيرها من حيثُ المعنى والنطق والاستخدامِ والقصد، وهو ما أدَّى بعدها إلى ظهور عِلم البلاغة بأقسامِه البيان والبديع والمعاني.
البلاغةُ العربيَّة اعتمدت التقسيمَ الثلاثي ولم تتجاوزَه، حتى وصفه البعض بعلمٍ بلغَ منتهاه ولم يعد هناك من إمكانيَّة لزيادته؛ ما جعلَ العرب يتجهون إليه بالتعلُّم والدراسة ومحاولةِ الإحاطة بأسراره وتفاصيلِه، فظهرت طائِفة من العلماء البلاغيين الذين أصبحُوا سادة السَّاحة الثقافية وأهمَّ شخصياتها المؤثرة، ومعهم اتَّخذت مقاربة الإبداع مسلكاً مختلفاً، حيث لم يعد كافياً استعمال العبارات التفضيليَّة وكَيل المديح للشاعر، بل ينبغِي أن يتمَّ بيان سبب إجادته وتميُّزه عن البقية، وهنا ظهرَت الكتابات المقارِنة بين الشعراء مِثلما بين المتنبي وخصُومه أو بين الطائيَّين أبي تمام والبحتري.
الكتبُ الخلافيَّة والتفضيليَّة أثارت المعارك بين الأُدباء والبلاغيين ودفعت الحياةَ الثقافية إلى الأمام؛ لأنها اهتمَّت بالجوانب الجمالية إضافةً إلى المجالات السَّائدة والمفضَّلة لدى عمومِ الناس، كما أن ارتباطها باللغة وعلاقةِ اللغة بالقرآن والدين أعطاها أهميَّة أكبر فجذَبت المزيد من الأنظار، وهو ما يعني تأثِيرَها البالغ في الحياةِ العلمية والثقافية خِلال تلك الأزمنة، لهذا لا يُعتبر غريباً أن يلجأ العلماء إلى دراسةِ الكتابات الأدبية والتعمُّق فيها؛ لاستخراج مزايا إبداعِها وأسباب عظمتِها وإعجازِها، كما فعل المعري في شرحِه لديوان المتنبي حينَ سماه مُعجِز أحمَد، إذ البلاغة اُعتبرت العلمَ الأهم؛ لكونها تكشفُ عن الفوارق بينَ الكتابات.
الانتقالُ من الرأي الإجمالي والخالي من التَّعليل إلى البلاغي والتفصيلي رافقهُ تقعِيد للمعارف والعلوم، فجاءَت كتب الأدب تضعُ قواعد للكتَّاب ناشرةً الأنظمة والقوانين اللازمة التي ينبغي عليهم معرفتُها، حتى أصبح لكلِّ علم استقلال عن الآخر، فتمَّ التفريق بين الشِّعر والنثر، ثم التفريق بين أنواعِ النثر؛ حيث وُضِع لكل لونٍ نثري قوانينُ تنظيمية تمَّ أخذها من الأجناس المنتشِرة في الوسط الثقافي السائد، فاللغويون والبلاغيون قاموا باستقراءِ الأنواع الأدبية السَّائدة واستخرجوا منها أنظِمتها وقوانِينها، وهو ما يُماثل ثقافة العصرِ وطريقةَ التفكير فيه، من ناحية انتشار المنطقِ الأرسطي القائمِ على الملاحظة والاستقراء، وهو ما اتَّضح في استقراء بحُور الشعر وتأليفاتِ البلاغيين.
انتشرَت الكتابات البلاغية الهادفة إلى تسليطِ الضوء على الإبداعِ شعراً ونثراً؛ ما جعل المؤلِّف يتوارى ويختفي عن الأنظار، فالحاجة إليه لتعليلِ ما يكتُب أضحت بلا معنى؛ إذ المسلك البلاغي مسلكٌ تعليمي بالأساس يهدفُ إلى نشر ثقافة اللغة وتقويةِ المعرفة بها، ولهذا لا حاجةَ لوجود المؤلِّف، وهو ما قادَ إلى حصره ضِمن بقعة ضيِّقة تتلخَّص في دائرة المعاني والمقاصد، التي لا يمكنُ الوصول إليها إلا عبرَه، فحصل توازنٌ داخل العملية الإبداعيَّة بين الهدف التعليمي والمعاني والمقاصد، واستمرَّ الحال حتى امتلأ الفضاءُ الثقافي بالشُّروح والهوامش وهوامشِ الهوامش، حيث الكتَاب يتمُّ شرحه وإعادة شرحِ الشرح والتهميش على شرحِ الشرح بهدف الوصول إلى مَقصَد الكاتب، وهو ما جعلَ الكثير من الكتابات تتضخَّم وتبلغ شُروحها العشرات وربما تجاوزت المئة.
ازدحامُ الفضاءِ بالشروح والتركيز على مقصدِ الكاتب أدَّى إلى أن يتوارى الجانبُ البلاغي قليلا، إذ لم يعُد له من فاعلية كبيرة بعد أن تم بيان جميع الأوجه والفنونِ المتعلِّقة به، بل وصل الأمر إلى امتهانِ الألعاب اللفظية والمسالك الإلغازية لاختبار الأشخاصِ واكتشاف قدرتهم على معرفةِ هذا النوع أو ذاك، فتحولت الكتابة إلى ما يشبه الألعاب مُبتعِدة عن مقاصدها السامية وأهدافِها العُليا، وإن استمرت على طريقتها في الاهتمام بالجانبِ البلاغي وإعطائه الأولوية أثناء التألِيف، لكن ذلك سيتغير مع حضور الدرس الأكَادِيمي في الجامعات والمعاهد، حيث اهتمَّ بالبلاغة في البداية قبل أن يتجاوزها إلى وضع مناهجَ أخرى كالتاريخي والنفسي والاجتماعي، فتحركَت مِياه النقد الراكدة وبدأت تستشرفُ التغيُّرات الجديدة، مطبِّقة ما جاء فيها من أنظمةٍ ومعايير على كتابات عصرها والعصورِ السابقة.
ظلَّت مسألة المؤلِّف مهيمنة على الدرس النقدي، فبعد إزاحةِ البلاغة عن واجهة المقاربة وابتعاد المناهجِ عن التعليمية؛ استمرَّ حضوره في كل درسٍ من دروس النقاد، الذين أخذوا يصطدمُون مع مقاصده ومعانيه، ولم يستطيعوا تبيُّنها على حقيقتها في كلِّ الأوقات، إذ كثيراً ما تكون الكتاباتُ غير واضحة المعنى بالنِّسبة للقارئ؛ لاحتوائِها على رموزٍ خاصَّة وشيء من بيئة الكاتب وثقافتِه وتجاربه وهو أمرٌ لم يكن ميسوراً للجميع معرفته؛ لذا أخذوا في الاتجاهِ ناحية إيجادِ مناهجَ تأخذُ على عاتقها دراسة الأدب بعيداً عن كاتبه، وهنا حضرَت القطيعةُ مع المؤلِّف وتمَّ اعتباره ميتاً من أجل إتاحة المعاني أمامَ القارئ، الذي سيتولَّى من الآن فصاعداً مهمَّة تفسير العمل الأدبي وكشفِ ما فيه.
الانتقالُ من المؤلِّف إلى القارئ حمل معه مناهجَ مختلفة عن السابق حيث لم تعُد تنفع في المقاربة؛ ما أدَّى إلى ظهورِ مناهج دراسية أكاديميَّة، نشأت في أحضانِ الجامعات والمعاهد المتخصِّصة؛ حيث أخذت على عاتقها مهمَّة كشف الإبداع الأدبي وكيفيَّة تكوُّنه وتفسير عباراته واكتشافِ معانيه وتأويل مقاصده، ونتيجةَ العمق الذي وصلت إليه العلومُ الإنسانية واستفادتها من بعضها تنوَّعت المناهج وتعدَّدت واختلفت مقارباتها، حتى أنَّ بعضها ربما عارضَ بعضها فيما يتمُّ التوصُّل إليه من أسبابِ الإبداع أو نتائج المقاربات، وهو إشكالٌ برز مع الاختلاف والتنوُّع واستمر باستمراره ولم يصِل إلى حلول نهائية إلا عبر الإطاحةِ بالناقد نفسه واستبدالِه بالقارئ، الذي سيكون مسؤولاً عن تقديمِ مقاربة شخصيَّة غير ملزمة لأحد باستثنائِه هو، وهذا ما فتحَ الباب أمامَ الناقد الحدِيث.
المناهجُ والمدارسُ النقدية باتت من الماضِي فالأولوية أصبحَت للقارئ، الذي بإمكانِه تقديمَ مقاربة لأي عملٍ أدبي وإبداعي، ومهما بالغَ في نتائجه وتأويلاته ستُعتبر صحيحة لكونها نابِعة من ثقافته وخِبرته ودراسته؛ ما تسبَّب بدخول أعدادٍ متزايدةٍ إلى مجال القراءات النقديَّة، رُغم أنهم لا ينتمون إلى المدرسةِ الأكَاديمية ولم يأخذوا معارفهم من خلالِ الجامعات والمعاهد، إذ يكفي القارِئ أن يقوم بالتَّعبير عمَّا يجول في نفسه من انطباعٍ عن النص الأدبي الإبداعي؛ ليتمَّ الاحتفاء بكلامه والأخذِ به باعتباره صادراً عن ذاتٍ قارئة، حيث لكل ذاتٍ قارئة قيمةٌ لا تقل عن بقيَّة الذوات، مهما كانت تمتلكُ تلك الذوات من العلومِ والمعارف والشهادات، وهذا الأمر استمرَّ وانتشر بصورة كبيرةٍ مع انفتاح العوالم الافتراضيَّة.
احتلَّ القارئُ مكانة الناقد حتى بات جزءاً من المشهدِ لا يجوز إهماله، ومن أعطاه قيمته القرائية أسهم كَذلك في رفدِه ما يحتاج إليه من أدوات تُسهِّل إيصاله لأفكاره، وهنا حضرَت وسائل التواصل وبرامِج السُّوشيال ميديا المنفتِحَة على جميع العوالم، التي أصبحَ معها القارئُ عالميًّا بعالميتها وانتشارها، فلا حُدود يمكن أن تمنعَ مروره وعبوره إلى ثقافاتٍ ولغاتٍ خارجةٍ عنه، ومع امِّحاء الحدود وغياب الأولويات الأكاديميَّة غدا الفضاءُ أشبه ما يكون بالفوضَى، إذ الكتاباتُ الإبداعية أُتيحت للجميع ومن ضمنهم الراغبُون بالكتابة لكنَّهم لا يجيدونها، والراغبون بالقراءة لكنهم لا يمتلكُون قواعِدَها وأنظِمَتها.
القارئُ العالميُّ هو أحدثُ نسخة من نُسخ الناقدِ الأدبي، الذي ظلَّ محافظاً على مكانته لقرون، لكنَّه الآن تنازل عنها لصالحِ الوافد الجديد القادرِ على تقديم قراءاتٍ سريعة، بناء على مُعطياتٍ تختلفُ أشد الاختلاف عمَّا يمتلك من خبرات وإمكانياتٍ واكتسب من معارفَ ومناهج، لا حاجةَ به لكلِّ هذا العمق لقراءة مقطوعاتٍ قصيرةٍ أو كتاباتٍ طويلة، هو يحتاجُ فقط إلى ثقافته الخاصَّة وخبرته المتراكمة وقدرةٍ على الاستكشاف؛ لكي يصلَ إلى مراده في إدراكِ المعنى والقصد من المكتوب، وهذا ما وضعَ النقد في أزمةٍ حقيقيَّة ليس من السهل الخروج منها بعد ما انتشرَت وشاعت وغدت أمراً اعتياديًّا وممارسة مقبولَة.
القارئُ العالميُّ نتاج ثقافة السُّرعة والإيجاز، حيث النصوص الإبداعيَّة تخضع لشرط المقروئية على منصَّات السُّوشيال ميديا ووسائل التواصل، لهذا تهربُ من الطُّول المسهِب مُكتفِية بكلمات موجزةٍ تؤدِّي المعنى وتقودُ إلى القصد بعيداً عن احتمالاتِ التأويل، وهذا الأمر لا يختصُّ بثقافة دون أخرى إذ جميعُ الثقافات تشتركُ في الهرب لكونها تخضعُ لقوانين واضعِ البرنامج ومؤسِّس المنصَّة، فوحدهما من يمتلكان مفاتيحَ سماحِ ومنعِ النشر عبرها، وما استجابةُ القارئ إلا قبولٌ بهذه الأنظمة والقوانين الجدِيدة، التي أصبحت حاكمةً على الفضاءِ الواقعي مثلما فرضَت نفسها على الفضاءِ الافتراضِي.
ابتدأَ الناقدُ من مُستجِيب للحظة الإبداعية متبعاً ذوقه في التَّعبير عنها إلى أن وصل مرحلة الاستقراء، قبلَ أن يبلغ حالة الأكَادِيميَّة في تقديمه للقراءات، ثمَّ مع الارتحال إلى عالم السُّوشيال ميديا تضاءَل حضوره واحتلَّ القارئُ مكَانه، ولأجل أن يعودَ عليه ممارسة أدوارٍ مغايرةٍ، حيث تظهرُ في كل مرحلة تحدياتٌ كبرى وتحدِّي المرحلة يتمثَّل في استكشاف المستقبلِ عبر فتح آفاقِ الأجناس الإبداعيَّة، من خلال قَولبة قوانِينها وأنظِمتها وإعادة رسمِ تفاصيلها؛ بهدف تصميم ِكتابات مُناسِبة للمستقبل، هكَذا يستعيد دَوره وينتقلُ من المنطقِ الاستقرائي إلى المنطقِ الاستراتيجي؛ ليكُون هو واضعُ القوانينِ وراسمُ الخُطط.