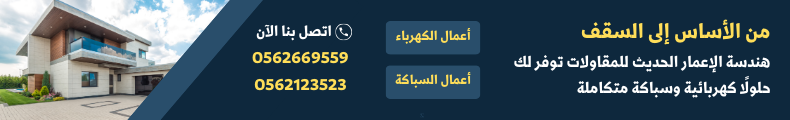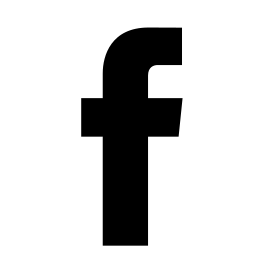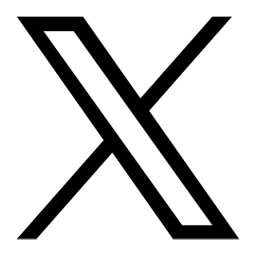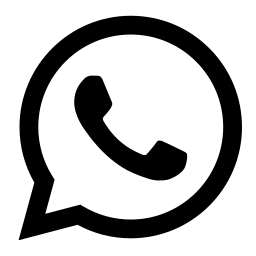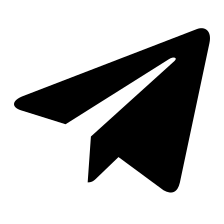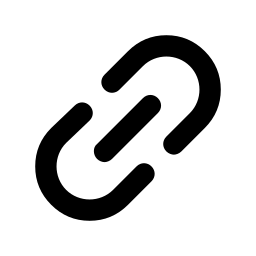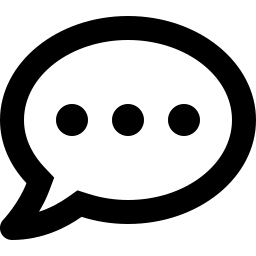الذي يغلبني دائمًا
المسك:
- إلى متى وأنتَ تتجوّل في مكتبات العالم؟.. عن أي شيء تبحث بالضبط؟.. وما سِرُّ اهتمامك بعالم القصة والرواية حتّى سمّيت نفسك بـ «الرّوائياتي»؟.. ولماذا هذا الجمع وأصل الكلمة روائي أو راوي؟.. أنت شخص غريب بالفِعل!.
الروائياتي:
- سأظلُّ أتجوّل في مكتبات العالم باحثًا عن الحقيقة؛ هذا أولاً، وثانيًا أستزيد من معرفة الماضي والحاضر والمستقبل، وما بعد المستقبل أيضًا، والوقوف على الواقع من خلال ما سطّره الإنسان في كتبه عبر التاريخ، وأقارن بين ما هو صحيح وغير صحيح، وواقعي وغير واقعي، وحقيقة ومحض افتراء وباطل، وحِكمة إنسانية وهرطقات شيطانية، ولا أنسى أن القراءة في كتب البشر توقفني على جادّة الصواب إلى حدّ اليقين بعد أن أتفاجأ من تعدد السُّبل التي يتّخذونها في حياتهم طوال حِقب التاريخ حتى يومنا هذا؛ بعد أن أعرض طرقهم تلك على كتاب خالق الوجود.
أمّا سِر اهتمامي بالقصة والرواية فأنا امتثلت لقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ?? أَخْلَدَ إِلَى آلْأَرْضِ وَآتَّبَعَ هَوَىهُ فَمَثَلُهُ? كَمَثَلِ آلْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَّلِكَ مَثَلُ آلْقَوْمِ آلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـ?َايَتِنَا فَآقْصُصِ آلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ .
فالقصص من الواقع الحقيقي أو من الحكواتيينَ أو القصّاصين أو الرُّواة كلّها محطّات للتفكُّر، بحيث نستخلص منها العِبَر والفوائد الجمّة إذا ما قارنَّاها بحياتنا على مسرح واقعنا الذي نعيش عليه، أو قاربْنَاها مع حكايات وقصص وروايات أخرى نقلها أو كتبها آخرون، ثم إنَّ القضايا الفكرية البحتة دون التمثيل الحكائي أو القصصي أو الروائي مملٌّ للكثير من المتلقين، ولكنهم عندما تتحدث معهم بالمقارنات النصّية والمقاربات المعنوية من الحكاية والقصة والرواية فدافع الفضول يجذبهم إليك أكثر من أيّ أسلوب آخر.
أما عن تسميتي بـ «الرّوائياتي» فهو مجردُ اسمٍ له دلالة على ما أُكثِرُ من الاهتمام به في حياتي، و”الرِوَائِيُّ من مادة [ر وي] وهو مَنْسوبٌ إلى الرِّوايَةِ» هُوَ رِوائِيٌّ مُمْتازٌ» مَنْ يَكْتُبُ رِواياتٍ مِنَ الخَيالِ أَوْ بِحَبْكِ وَقائِعَ مِنَ الحَياةِ بِأُسْلوبٍ شَيِّقٍ وَيُقَدِّمُها في صُوَرٍ تَتَحَوَّلُ إِلَى قِصَّةٍ طَوِيلَةٍ“، والمبالغة باب معروف في اللغة ويمكننا التعرف عليه في علم الصَّرف أو التصريف، وصِيَغ المبالغة مُتعددة، ومنها «فعّال» كأن تقول عن الذي ينجر الخشب أي نَحَتَه وسوّاه بكلمة «النَّجار» ونجَّار كلمة على صيغة «فَعَّال» أي كثير الفعل، والنّجار أيضاً كثير النّجارة، كذلك «الرّوائياتي» جاءت من كلمة «الرّوائيات» وهنا لا يقصد بها جمع رِاوئية أي الأنثى التي تروي، وإنما يُقصد بها كينونة النص اللغوي الذي يعطي في مُجملة رواية شيءٍ ما، كأن تقول مثلاً: حالَة رِوائية.. أو كلماتٌ وجُملٌ وفقراتٌ رِوائية.. وهكذا.. لذلك جاءت كلمة ال «رِوائياتي» كنسبة لهذه الكلمة.
أما بخصوص اتّصافي بالغرابة، فالغَرابة ”مصدر غرُبَ/ غرُبَ عن وغرُبَ غرابة ذهن: ما يحيد عن المفهوم العام أو عمّا هو معتبر معقول، - غرابة ذوق: ما يجعل الشّيء غريبًا مختلفًا عن غيره وخارجًا عن المألوف، - غرابة سلوك: طريقة تصرُّف خارجة عن العادات المألوفة أو بعيدة عن الطريقة التي يتبعها عامّة الناس، - في كلامه غرابة: غموض، - يا لِلغرابة“، وهذا استنتاج صحيح منك - أيها المِسك - لأنني بالفِعل لجأت إلى ما لا يلجأ إليه عامّة الناس في اتّخاذي هذا الطريق مسلكاً للتفكير، ولكنه مُباح على أيِّ حال، لأنني أصل إلى نتائج سليمة بعد تحكيم العقل والمنطق والفطرة السليمة.
- الآن.. قل لي ما لديك اليوم لتتحفني به؟.
- سأتحدث معك اليوم عن ذكريات قديمة تدور في ذهنك، وقد قرأتها بعناية وتركيز، في سجلّ ذكرياتك الداخلي، وستستمتع بها وأنت تسمعها منّي.
- قل ما لديك.
- أتذكر الألعاب التي كنت تمارسها في صِغرك مع أخيك غير الشقيق عبد المحسن بن عباس بن عبد المجيد المسكين، وكان يغلبك دائماً ولم تنتصر عليه في أيّ لعبة من الألعاب طوال حياتك منذ أن وعَيت على الدُّنيا وأنت في الأول ابتدائي عام 1394 هـ حتى الأول الثانوي عام 1404 هـ؟
- لماذا تُقلّب عليَّ هذه المواجع الطريفة؟.
- ”وراءَ الأكَمَةِ ما ورائها“.
- وما وراء أكَمَتِكَ أيها «الرِّوائياتيّ» الفيلسوف؟
- لقد كان أخوك مُتمرسًا في لعبة كرة القدم وهو معروف في الحارة، وبالذات في فريق الحواري الذي كان يُسمى وقتئذٍ بفريق «النجم»، وكان هو أفضل اللاعبين بهذا الفريق، بل كان هو الكابتن للفريق في حالة وجود مباريات مع أفرقة أخرى؛ وهذا ما نفعه ليكون من اللاعبين المرموقين في مرحلة البراعم والأشبال والشباب والناشئين والدرجة الأولى بنادي الخليج، بل لعب فترة في منتخب المنطقة الشرقية أيضًا، أما أنت فلم تكن كذلك، لأنك لم تتمرّس جيداً في هذه اللعبة، بل لم تعطها اهتمامك الأكبر، لذلك فهو أفضل منك ويتغلّب عليك دائماً.
أما في الألعاب المنزلية التي كنتم تمارسونها في مجلس بيت الجدّ الحاج عبد المجيد بن محمد المسكين، الذي بجانب بيت الشيخ عبد المجيد بن الشيخ علي أبو المكارم، أو في بيته الثاني خلف سوق الخضار بمحاذات عمارة البيات، فكان أيضًا يتغلب عليك لأنه كان يمارس هذه الألعاب ك «الكيرم» و«الزّاتة - الكوتشينة -» و«الصبة أم ثلاث» و«الصبة أم تسع» و«الدومينو» وغيرها، وكانت ممارسته لهذه الألعاب لها طابع الكثرة من جهةٍ لا سيما في أوقات فراغه مع أبناء وبنات الحاج عبد المجيد وهو قد تربّى معهم، ومن جهةٍ أخرى لأنه يلعب مع الآخرين بذكاء وحصافة أما أنت فتلعب بعشوائية ودون تحكّم بما تراه أمامك من النَّقلات أو مراحل اللعب، كما إن أخيك كان يلاحظ أسلوبك أو أساليب اللاعبين واللاعبات معه فيكتشف طريقتك أو طريقتهم وطريقتهنّ أو يخمّن ذلك، فيضادّهم في هذه الأساليب بما يقهرها ويُضعفها، وهنا السرّ الحقيقي في الفوز على الخصم، لذلك يكون فوزه في هذه الألعاب أسرع من غيره.
- وما وراءَ الأكَمةِ أيضًا أيها - الروائياتي -؟
- سؤالٌ في محلّه، أما الجواب فإنّك كنت تعيش في بيئة أخرى ببيتكم العود في الديرة، والبيئة التي عاش فيها أخوك عبد المحسن تختلف تماماً، واختلاف البيئة المكانية وعوامل التربية والتأثّر بالمحيط الاجتماعي من حول الإنسان كفيل بتغيير مستويات ذكاء الإنسان وحُسن تصرفاته ونجاحه، فالمعروف عن الحاج عبد المجيد المسكين هو كونه من الحريصين على التزام أبنائه وبناته - بشكل مُجمل - على النظام، وعبد المحسن اكتسب ذلك وتفوق أيضًا.
- وماذا لديك في هذا الموضوع أيضًا لأنني أشعر بأنك لم تنتهِ بعد؟!.
- لقد أخفيت في نفسك شيئًا وأنا معك في ما أخفيتَهُ، بل أؤيّدُهُ أيضًا.
- وما هو؟.
- كنتَ تقول في نفسك: ”لم يا أخي لم تجبر بخاطري ولو مرة واحدة وتجعلني أنتصر عليك، حتى لا أشعر بحالةِ الفشل أمام ذاتي وأمام الآخرين؟!.. ولو من باب المجاملة الظاهرية، والتشجيع المعنوي ليْ حتى ترتفع معنوياتي وأتحسن في طُرق اللعب كما تتقنها أنت، أو لماذا لم تعلّمني أسرار هذه المهارات في اللعب؟!.. لماذا استأثرت بها لنفسك لترتفع في عيني وعيون الآخرين، أما أنا - وأنا أخوك - لم تجاملني ولم تقدّر صِغري وطفولتي البريئة، وأنت تتشطّر على أمثالي لتعلنَ فوزكَ دائماً عليَّ وعلى بقيةِ أبناء جدّك عبد المجيد؟!“.
- نعم.. نعم.. كنت أفكر في ذلك، ولكنني لم أتحدث به لأحدٍ على الإطلاق، لأنني بصراحةٍ كنتُ أخاف من أخي عبد المحسن؛ ولأنه يكبرني سنًّا؛ ولأنه يعيش في بيت جدّه وأنا أخاف من جدّه أيضًا، لذلك فضّلتُ السكوتَ ولم أنطق ببنت شفة في هذا الموضوع.
- صحيح، لم تتحدث عن ذلك مطلقاً، وأنا متعجب من أخيك الأكبر هذا، حيث كان بإمكانه أن يداريك ويجاملك في مختلف الألعاب لتتقنها وترفع رأسك أمام ذاتك أولاً وأمام الآخرين ثانياً، وهذا الخلق معروف عند الرياضيين ف ”في العديد من الأحداث الرياضية، نرى أحيانًا رياضيين يتنازلون عن فرصتهم في الفوز لدعم أو تمكين منافس آخر. وعلى سبيل المثال في سباق الماراثون، قد يتوقف رياضيٌّ لمساعدة منافس آخر تعرض للإصابة أو الإرهاق، حتى لو كان ذلك يعني خسارة فرصة الفوز بالميدالية“، ثم إن أخلاق الإيثار معروفة في تاريخنا الإسلامي بشكل عام، منذ زمن الرسول الأعظم ﷺ وعهود الأئمة  ، والأمثلة كثيرة لا حصر لها، وبالذات بين الاخوة الأشِقّاء، وهناك أمثلة بين المؤمنين أنفسهم ولو لم يكونوا أخوة أشقاء لأنهم يقدسون الأخوّة في الله وفي الدين والعقيدة، كما نقرأ في التاريخ أيضًا عن الإمبراطور الروماني ماركوس أوريليوس وهو مثال جليّ ”على الشخص الذي يضع الخير العام فوق مصلحته الشخصية، حيث كان يتظاهر أحيانًا بالهزيمة في المعارك السياسية ليحافظ على استقرار الإمبراطورية ويجنبها الفوضى، وكان دائمًا يفضل تحقيق السلام والعدالة على حساب مصلحته الشخصية“.
، والأمثلة كثيرة لا حصر لها، وبالذات بين الاخوة الأشِقّاء، وهناك أمثلة بين المؤمنين أنفسهم ولو لم يكونوا أخوة أشقاء لأنهم يقدسون الأخوّة في الله وفي الدين والعقيدة، كما نقرأ في التاريخ أيضًا عن الإمبراطور الروماني ماركوس أوريليوس وهو مثال جليّ ”على الشخص الذي يضع الخير العام فوق مصلحته الشخصية، حيث كان يتظاهر أحيانًا بالهزيمة في المعارك السياسية ليحافظ على استقرار الإمبراطورية ويجنبها الفوضى، وكان دائمًا يفضل تحقيق السلام والعدالة على حساب مصلحته الشخصية“.
أما في عالم الروايات فنقرأ في رواية البؤساء لفيكتور هيغو حيث ”نجد شخصية جان فالجان الذي يتظاهر بالهزيمة والخسارة بشكل متكرر من أجل الآخرين في عدّة مواقف، ويضحي بحريته ليعترف بذنبه لإنقاذ رجل آخر بريء، وفي نهاية الرواية يتخلى عن حياته الهادئة ويسعى لمساعدة كوزيت وماريوس، مما يعكس روح الإيثار والنبل“.
وفي التاريخ الواقعي، وعالم القصص والروايات الكثير من الأمثلة التي ”تعكس الروح الإنسانية العالية والإيثار الذي يمكن أن يظهره الإنسان تجاه الآخرين، واضعين احتياجات ومصالح الآخرين فوق مصالحهم الشخصية، مما يعكس قمة النبل والأخلاق“.
- صدقت أيها الرّوائيّاتي العجيب رفي كلّ ما ذكرت، ولكنني رغم كلّ ذلك لازلتُ أكنّ لأخي كاملَ الاحترام والتقدير، و”عمر الظفر ما يطلع من اللحم“، حتى لو غلبني في كل الألعاب وقتئذٍ.
- أُحيّيك على هذه الروح الرياضيّة المرنة، ولكن!.