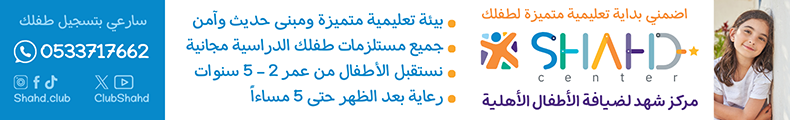استراتيجية عملية للأزمة الاقتصادية العربية
العالم بأسره، ومن ضمنه وطننا العربي، يمر بأزمة اقتصادية حادة، بعضها يعود جذوره إلى الفروقات الشاسعة في النمو الاقتصادي والتي يتبعها بالضرورة، فروقات شاسعة بين الغنى والفقر. وبعض أسباب هذه الأزمة يعود إلى انتشار وباء «كورونا»، في السنوات الثلاث الماضية، الذي تسبّب في تعطيل مصالح الناس، وتراجع التبادل التجاري بين الدول، وكساد شمل كافة بقاع المعمورة. وتسببت الحرب الروسية - الأوكرانية، وانهماك الغرب بها، والعقوبات التي فرضها الغرماء على بعضهم، في تصعيد حدة الأزمة؛ حيث خلقت تلك العقوبات أزمة في مصادر الطاقة، تسبّبت في نشوء تضخم اقتصادي عالمي، جاءت لتضيف أحمالاً ثقيلة أخرى على كاهل من اكتووا بتراجع موازين الدخل لديهم، قبل نشوب الحرب.
ومما لا شك فيه أن البلدان الفقيرة، هي الأكثر معاناة وانسحاقاً، من تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة. فهذه البلدان تفتقر في العادة إلى التخطيط الاقتصادي، والتوجه نحو الإنتاج، فضلاً عن ضعف فرص الاستثمار الأمثل لمواردها. ويضاف إلى هذه الأسباب الانفجار المتسارع في تعداد السكان، بما يضعف إمكانيات حكوماتها في توفير الاحتياجات الرئيسية لمواطنيها، من سكن وتعليم وصحة وكهرباء، وعمل.
والوطن العربي، ليس استثناء في هذا السياق. فحيثما يمّمنا النظر في خريطة هذا الوطن من مشرقه إلى مغربه، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي، التي حباها الله بثروات ضخمة، مكّنتها من استكمال تأسيس البنية التحتية، والانطلاق إلى مجالات أخرى، فإن بقية أقطار الوطن العربي، تنوء بمشاكل اقتصادية صعبة، أدت إلى تراجع سريع ومريع في أسعار عملاتها. وكان من نتيجة ذلك، أن باتت بعض هذه الأقطار تعدّ في قائمة البلدان الأكثر فقراً في العالم.
بالتأكيد لا يمكن إدراج هذه البلدان جميعها في كفة واحدة، ولكن الخط البياني الصاعد، للنمو في جميع هذه البلدان يكاد يكون معدوماً.
بعض الأقطار العربية، تعيش أزمات سياسية حادة تُسهم، بالإضافة إلى العوامل التي أشرنا إليها، في انعدام أية إمكانية لتحقيق نمو اقتصادي حقيقي، أو التوصل إلى حل عملي للخروج من عنق أزمتها الاقتصادية. بعض حكومات هذه الدول قدّم تنازلات سياسية باهظة لقوى دولية وإقليمية، على حساب السيادة والكرامة، ولكنها لم تفضِ إلى تحقيق حلول عملية لأزماتها الاقتصادية. وبعضها الآخر، لجأ إلى صناديق القروض الدولية، التي فرضت قيوداً كبرى، من ضمنها خفض العملات المحلية، وقد أسهم الخضوع لتلك الشروط في مضاعفة الأزمة بدلاً من إيجاد حلول عملية لها.
إن من شأن استمرار هذه الأزمة، التسريع في انتشار الجريمة، وتحقيق انهيارات اجتماعية شاملة، وربما ينتج عنها الحروب الأهلية، وتفكيك لوحدة هذه البلدان، بما يهدّد مستقبل ووجود المنطقة بأسرها، خاصة أن الأزمة ليست حصراً على بلد بعينه، وإنما باتت أفقية تمتد من البحر إلى البحر.
بمعنى آخر، لم تعد الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها معظم البلدان العربية، أزمة وطنية، تخص شعوبها فقط، بل باتت أزمة تهدد بنتائجها الكارثية الوطن العربي بأسره. وبات الحاضر والمستقبل، يستصرخان العرب، قادةً وشعوباً، كلٌّ من موقعه، إلى مناقشة هذه الأزمة ومخرجاتها، وسبل تجاوزها. وإذا لم يتم التسريع في صياغة استراتيجية عربية عملية وشاملة للخروج من هذه الأزمة، فلن يكون أمامنا سوى الطوفان.
الحلول الجزئية، كتقديم الهبات والقروض، ستكون مثل الحقن المهدئة لمرضى السرطان، وقد جُربت كثيراً لأكثر من ستة عقود، وسُرعان ما ينتهي مفعولها، لتعود الأمور إلى سابقاتها، أو أسوأ من ذلك بكثير. فتلك الهبات والقروض، التي تقدّم عن حسن نية، لا تذهب إلى الوجهة المبتغاة منها، ولا تُسهم في تحقيق تنمية حقيقية، بل تتجه، في أحسن الأحوال، نحو مقابلة استحقاقات العمل اليومي الروتيني، لأجهزة الدولة، ولا يطال الجمهور منها شيء يستحق الذكر.
المعالجة العملية، للأزمة الاقتصادية، ينبغي أن تركز أولاً على تخفيف حدة الارتباط بمشاريع الإقراض العالمية، وتعمل على إنشاء صندوق عربي مشترك، لا يقدم قروضاً أو هبات مجانية، بل يعمل وفق تخطيط متقن، على نقل البلدان العربية التي تعيش أزمة اقتصادية حادة، من حال إلى حال. وضمن التخطيط ينبغي التركيز على الاقتصاد المنتج، والاستثمار العلمي الأمثل لمختلف الموارد، بما في ذلك الموارد البشرية، ودخول التقنية بشكل واسع في مجال الزراعة والتصنيع. وتأسيس هيكلية اقتصادية عربية موحدة، تعمل في النهاية إلى تحقيق سوق عربية مشتركة، بعملة نقدية واحدة.
هي أحلام كبيرة، نتطلع إليها، ولكنها إرادات كامنة، متى ما امتلكنا الوعي والتصميم، وهي بحاجة إلى قراءات أدق وأعمق في قراءات قادمة.