خطايا نوبل وقداسة الأسماء الكبيرة
نوبل ذات سمعة عالية عالميًا تسعى لصيانة مكانتها وضمانها عبر تحسس ردود الأفعال المحلية والعالمية مما يحتم عليها الاستقراء السياسي لأفعالها.
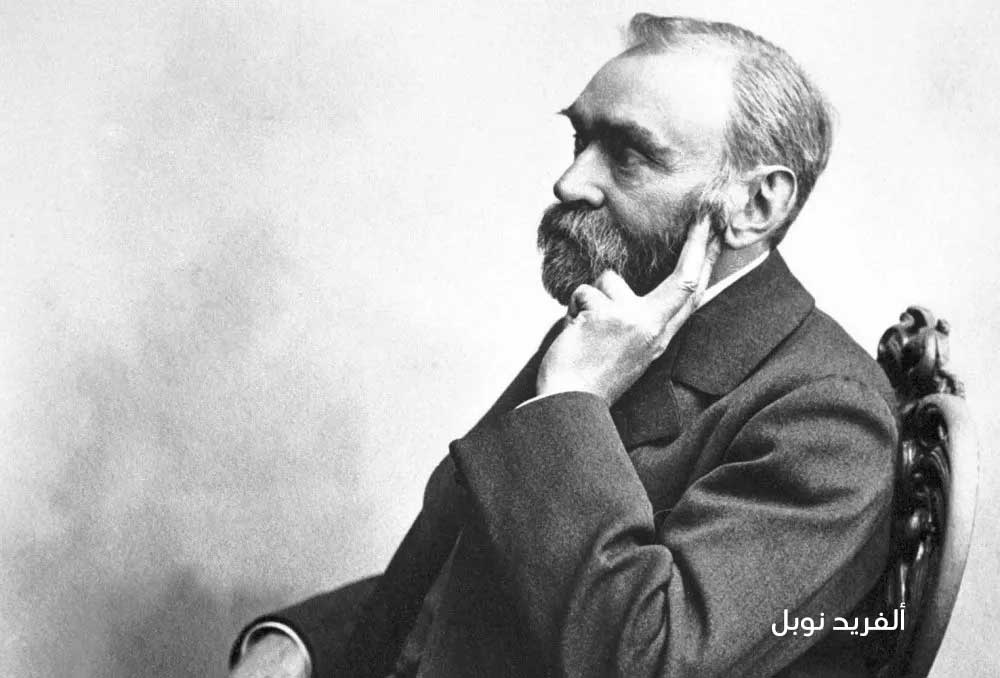
«مات تاجر الموت!»
استفزّ هذا التأبين رجل الأعمال والكيميائي ألفرد نوبل حينما قرأه عن نفسه، حيث أخطأت بعض الصحف وظنّت أنه هو من توفى عوضًا عن أخيه لودفيج. وظنّ نوبل بسذاجة أن اختراعاته للمتفجرات ستساهم في إنهاء الحروب؛ إذ دار في خلده أن فكرة إفناء مجموعة كبيرة من البشر بهذه الطريقة وبهذه السرعة فكرة رادعة لكل الأطراف؛ ولذا لن تقوم الحرب ابتداء.
حثته قراءة هذا الخبر بابتكار طريقة يحسّن فيها سمعته، فلا يكون إرثه «تجارة الموت»، فأدّى ذلك إلى الجائزة الشهيرة التي صارت تُعرف باسمه وتعطى في خمسة فروع قرّرها هو في وصيته: الطب والفسيولوجيا والفيزياء والآداب والسلام والكيمياء. وأضيف لها فيما بعد فرع الاقتصاد بعد ذلك بعدة عقود.
وباتت هذه الجائزة هي الأشهر في العالم، مضرب الأمثلة ومهوى الأماني، ولك في النزاع بين يوسف إدريس ونجيب محفوظ مثالاً، فمن هو الأحق بنوبل وهل انتزعها محفوظ من إدريس لصدامية إدريس مع إسرائيل بالمقارنة مع محفوظ الذي أيّد اتفاقية كامب ديفيد ونادى بالتفاوض مع إسرائيل؟
ويتفق ذلك الموقف مع موقف توفيق الحكيم الذي ترجم أعماله ونشره للعالم أبا إبيان، وزير خارجية إسرائيل السابق وشقيق رئيسها السابق وعم رئيسها الحالي. وهل فعلا يسعى لها أدونيس الذي رُشح لها مرارًا، وهل هذا هو دافع مواقفه الناعمة تجاه إسرائيل؟
وللجائزة أحيانا أثرٌ يتعدّى مجالها، فبسببها صار أحمد زويل - الحائز على الجائزة في فرع الكيمياء عام 1999 - شخصية عامة وحاضرة بقوة في المشهد السياسي والعام، وتناهت أخبار ترشحه لرئاسة مصر في انتخابات 2012 حتى نفى هو ذلك. بينما ظل جورج أندور أولاه، النرويجي الذي حاز على الجائزة في المجال نفسه عام 1994 محصورًا في مختبره ومحيطه العلمي طوال حياته دون أن تهبه الجائزة أدوارًا أوسع من ذلك.
ويبدو أن اللغط لم يكن يوما أجنبيًا عن نوبل منذ أول عام وزّعت فيه الجوائز في 1901، فكانت جائزة نوبل للآداب ذلك العام من نصيب الشاعر الفرنسي المغمور رينيه بوردوم. وقد هزّ المجتمع الثقافي السويدي تجاوز لجنة الجائزة لتولستوي، مما دفع أكثر من أربعين فنانًا وناقدًا بتوقيع رسالة للروائي الروسي يدينون فيه اللجنة وقرارها ويؤكدون على أن الجائزة لا تمثّل عموم الناس ولا حتى النخبة الأدبية!

وحين رُشح تولستوي في السنوات اللاحقة، قام كارل ديفيد، الشاعر السويدي والسكرتير الدائم للأكاديمية السويدية بالتصويت ضده معترفًا ب «أحقية» أعماله «آنا كارنينا» و«الحرب والسلام» بالجائزة، إلا أنه كان معترضًا على مواقف تولستوي السياسية والاجتماعية التي كان يراها غير ناضجة ومضللة وأنها ضد كل أشكال الحضارة، فمن الخطأ بحسب كارل ديفيد إعطاء الجائزة لتولستوي!
ولم يمنح تولستوي الجائزة لعدة سنوات متتالية، وفي عام 1905 تعالى احتمال فوزه بسبب رواية لا زالت مغمورة، بل حتى لم تُترجم إلى الإنگليزية إلى يومنا هذا، بعنوان «الإثم العظيم»، فشعرت اللجنة أن هذا العمل ارتقى بتولستوي.
وما إن تناهى إلى سمع تولستوي هذا الخبر هذه المرة حتى كتب لصديق سويديّ يحثه على ألا يألوا جهدًا في محاولة منع الجائزة عن تولستوي؛ لأنه لا يريدها، وسيشكل المال المصاحب لها حرجًا له، وانتهى الأمر إلى أن تولستوي لم يحزها بغض النظر عن السبب.
بعكس سارتر الذي فاز بالجائزة لكنه رفضها كلًا وتفصيلاً، وبرنارد شو الذي قبل الجائزة بعد تمنع ورفض المبلغ المالي، أو الفيتنامي لي دوك ثو الذي رفض جائزة نوبل للسلام حين فاز بها مناصفة مع هنري كيسينجر عام 1973 ساخرًا أن السلام لم يحل بعد، وفعلاً لم تكن الحرب قد وضعت أوزارها آنذاك.
وكذلك لم تُمنح الجائزة إلى مكسيم غوركي، مواطن تولستوي، ليس لعدم أحقية أعماله الأدبية، وإنما لمواقفه السياسية، فهو بالرغم من خصومته مع لينين الذي نفاه، إلا أن علاقته بستالين الذي أعاده لروسيا جيدة في مقابل الروسي الذي فاز بها إيفان بونين الذي هاجر من روسيا فور الثورة البلشفية عام 1918 إلى أوربا.
ولا غرابة بعد ذلك أن تعرف أن:
حوالي 80% من الجوائز ذهبت لأشخاص من دول تنتمي للغرب، وأن السويد، بلد نوبل، هي في مصاف الدول المتقدمة في الجائزة، فهي تأتي خامسة بعد الولايات المتحدة الأميركية ثم بريطانيا، ثم ألمانيا، ثم فرنسا.
واللغط الدائر حول نوبل ليس مقصورًا على فروع السلام والآداب التي قد يتسامح المرء فيهما باعتبارهما مواضيع تنفر من الموضوعية بطبيعتها. بل إنه حتى في الفروع العلمية:
فقد تسلّم أرنو بنزياس وروبرت ويلسون جائزة نوبل للفيزياء عام 1978 لاكتشافهما الموجات الصغرية الكونية الخلفية، فقد كانا يحاولان استخدام قرن استشعار ضخم وجداه في مختبر يعملان فيه وحاولا تجريبه، لكن ذلك كان مستحيلاً لكمية الضوضاء التي يلتقطها هذا القرن.
حاولا التخلص من هذه الضوضاء ليتمكنوا من التجريب شهورًا طويلة دون نجاح، فقررا التواصل مع جون دايك ليستشيروه ويساعدهما، وما كانا يعرفان أن دايك وكل مختبره كانوا يبحثون عن «الضوضاء» ذاتها التي كانا يريدان التخلص منها، ولكن دايك لم يكن يملك قرن الاستشعار الضخم الذي كان لدى بنزياس وويلسون.
فكانت مهمة مختبر دايك هي البحث عن هذه الموجات التي اقترح وجودها جورج غماو، منظرًا أن هذه الموجات هي أثر عملية الانفجار الكبير الذي أنتج الكون! وأدرك دايك على الفور أثناء الاتصال الهاتفي أنهما قد وجدا هذه الموجات دون أن يدركا ماهيتها.
ولم يدركا أهمية ما وجداه حتى قرؤوا عنه في الصحف! فصاحب النظرية هو غماو، ومن حاول إثباتها وأدرك اكتشافها هو دايك، ومن وجداها دون إعمال ذهني أو بإعمال ذهني غير مقتدر هما بنزياس وويلسون اللذان حصدا على الجائزة حصرًا.
وفي عام 1974 فاز بالجائزة أنتوني هويش «لدوره الحاسم» في اكتشاف النجوم النابضة «البولسار» بحسب المؤتمر الصحفي الرسمي، ومن اكتشف هذه النجوم فعلاً هي طالبته جوسلين برنيل التي عانت من تشكيك هويش لنظريتها وتقاريرها ظانًا أن ما وجدته هو محض اعتلالات كونّها البشر، إلا أنها ظلت متمسكة بحدسها حتى كتبت ورقتها العلمية معلنة بها اكتشافها.
بحسب الطبع المعمول به أصبح هويش هو الكاتب النهائي في تلك الورقة لأنه المشرف على جوسلين، وظفر بالجائزة دون أن تذكر أو تكافأ المكتشفة الحقيقية. وقد ثار الجدل في تجاوز لجنة الجائزة لجوسلين بورنيل عما إذا كان ذلك لكونها امرأة أو لكونها طالبة صغيرة العمر آنذاك.
ثم إن السياسي وطبيب الأعصاب البرتغالي أنتونيو مونيز حاز على الجائزة عام 1949 «لاكتشافه القيمة العلاجية لجراحة الدماغ في بعض حالات الذهان»، فهذه الجراحة هي تمزيق بعض المسارات العصبية الدماغية. وتلقّت الجراحة العديد من النقد المستحق حتى قبل تاريخ الجائزة باعتبارها ليست علاجية إلا بالمقدار الذي يكون فيها الموت علاجيًا في هذه الحالات!
أي أنها لا تفعل شيئا سوى شلّ القدرة الدماغية، سواء كانت هذه القدرة الدماغية عليلة أم لا، وستؤدي إلى النتيجة نفسها إن تمت على الأصحاء أو المرضى. وبالرغم من أن مونيز حقيق بالتاريخ عبر الجائزة لأسباب أخرى، فهو من اكتشف تصوير الأوعية الدموية الدماغية باستخدام الصبغة، وظلّت هذه الصبغة محورية في العمل الطبي حتى يومنا هذا.
ليست نوبل بالضرورة بطاقة عبور للشهرة العالمية، فإنك تجد بورخيس وبروست وجويس ومارك توين ناهيك عن الأسماء المذكورة آنفا التي لم تحز على نوبل قد ذاع صيتها إلى أصقاع الأرض، وإنك لن تعدم أن تجد من حاز على الجائزة وظل مغمورًا حين تتطلع على قوائم الحائزين عليها، مع الإشارة إلى أن الشهرة التي تحملها نوبل لحائزيها في الغالب محصورة في فروع السلام والآداب، مقارنة بالفروع العلمية.
وتتنامى عزلة جوائز نوبل في الفروع العلمية عن المحيط العام مع الزمن، بحكم أن العلم ينمو أسيا بلغة عازلة ويتبرعم كل فرع منه لفروع أخرى تنعزل هي الأخرى عن بعضها البعض، فيصبح المجتمع العلمي المعين أكثر ضيقًا أمام فسحة الأدب، الأدنى للناس بعمومهم.
هذه الأمثلة تنزع بعضًا من القداسة من جائزة نوبل، فهي ليست ضمانًا للخلود، وليست معصومة من الخطأ سواء في إعطاء الجائزة أو في منعها، حتى حين تحاكمها بمعيارها الذي وضعته لنفسها وذلك المعيار هو وصية نوبل التي تقتضي على ألا تفرّق الجائزة بناء على الجنسيات وأن تُمنح بناء على الجدارة.
وإنما هي جائزة ذات سمعة عالية عالميًا تسعى لصيانة مكانتها وضمانها عبر تحسس ردود الأفعال المحلية والعالمية مما يحتم عليها الاستقراء السياسي لأفعالها والتصرف بناء عليه. حتى يتسنى لها أن تقوم بدورها وهو أن تكون عتبة اعتراف عالمية بالمشهودية، يسلم بها المجتمع العالمي.
وبعد سوق هذه الأمثلة عن نوبل، تجدر الإشارة إلى أن هذا الحديث في العموم ينطبق على كل الأسماء الكبيرة، على غرار جامعة هارفرد.
فمدير أحد مختبراتها، الدكتور بيرو أنفيرسا الذي نشر عدة أبحاث ثبتها في أوراقه العلمية المنشورة، وأخذ من المؤسسات الحكومية المعنية بالبحث مبالغ مالية ضخمة لدعم أبحاثه في مجال الخلايا الجذعية في القلب.
وقد تبيّن لاحقًا أنه كان يدلس ويزور نتائج أبحاثه ليستحصل سمعة أكاديميةً طيبةً وأموالًا طائلة، واضطرت جامعته إلى دفع عشرة ملايين دولارًا للحكومة للتسوية. ثم راحت الجامعة تلاحقه في المجلات العلمية حتى تسحب هذه المجلات أوراقه العلمية، وبالفعل سُحبت واحدٍ وثلاثين ورقة.
وكثيرًا ما تلاحظ حالة من التواضع تصيب البعض حينما يسمع أن فلانا تخرج من هذه الجامعة، معتقدًا تلقائيًا أن هذا الخريج استثنائي بطبيعة الحال. وهذا مبرر وطبيعي، بل وضروري أحيانًا في الحياة اليومية، فذلك مثال على كثير من التصنيفات التي نستخدمها في حياتنا اليومية التي لا تستقيم الحياة بدونها.
فالإنسان لا بد أن يسلّم في كثير من الأمور اليومية، فهو سيسلّم للأخبار التي يسمعها من القناة الرسمية دون أن يتحقق منها هو بنفسه!
كما يسلّم إلى تطبيق الجو في جواله الذكي ذي الدقة المقبولة، وسيتصرف بناء عليه ويجهز مظلته لتقيه من المطر الغزير المتوقع، دون أن يراجع بنفسه العمليات الحسابية التي أدت إلى هذا التوقع، وفي أمر أقل أهمية عملية من ذلك في حياته اليومية، سيسلّم أن خريج هارفرد فريد ومتميز وأن خريج كلية ذات سمعة عادية سيكون عاديًا.
إن الانطلاق من هذه المسلمة، وهي التسليم بمخرجات المؤسسات ذات السمعة العالية، قد يكون منزلقًا خطيرًا في الأوساط البحثية والأكاديمية والعلمية في نهاية المطاف.
وينبغي أن يسعى العالم والمؤسسات العلمية والبحثية إلى المحايدة الصفرية في كل أمر، وأن ينطلق البناء على المسلمات العلمية التي يشكّلها المجتمع العلمي، ولها التشكيك في هذه المسلمات إن استطاعت، ثم الخطو تجاه حقائقها بالبرهان التجريبي أو المنطقي أو كليهما، دون اعتبار للزخرفات المصاحبة للمحتوى، سواء كان من شخص شهرته اخترقت أصقاع الأرض أو من مؤسسة بنت لها سمعة غير مضاهاة.
فهناك عوامل أخرى كثيرة تساهم في النتاج «العلمي»، فهذا النتاج ليس حكرًا على نية «التقدم بالعلوم»، فالأشخاص والمؤسسات تبذل جهدها لصيانة سمعتها ومصالحها وتنميتهما، والكل يتسابق إلى استخدام الأدوات الإعلانية التي تؤثر على سلوك المتلقي لصالح هذه المؤسسات بالقدر الذي لا يتعارض مع سمعتها.
إلا أن القاعدة العلمية تشي بأنه لا ينبغي ذلك! فهناك عدة آليات في النشر العلمي تحاول تحجيم الآثار الإرادية أو اللاإرادية التي قد تضلل النتيجة العلمية!
















