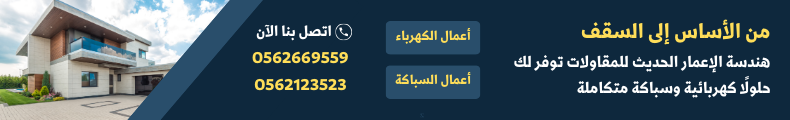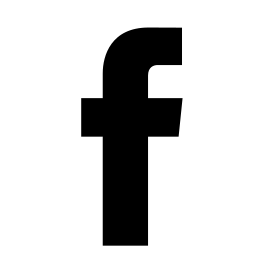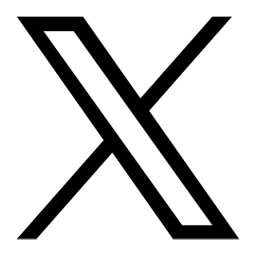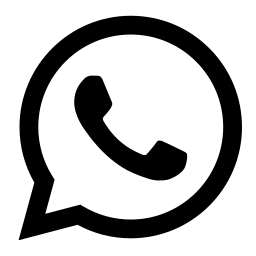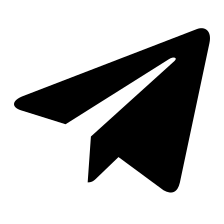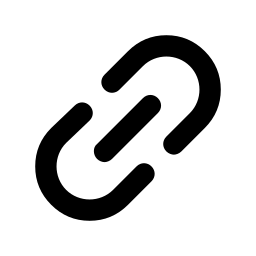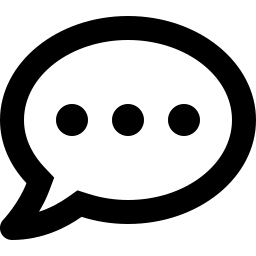الميراث في الإسلام بين عدالة التشريع ورهانات العصر
يُعَدّ نظام الميراث في الإسلام من أكثر الأنظمة الفقهية تعقيدًا ودقة، حيث يقوم على قواعد ثابتة مستمدة من النصوص القرآنية والسنة النبوية، وقد اجتهد الفقهاء عبر العصور في تأصيله وتفصيله وفقاً لرؤى مذهبية متعددة بين السنة والشيعة. غير أن أي نظام قانوني، مهما بلغ من الإحكام، يبقى خاضعًا لتحديات الزمن ومتغيرات الواقع، مما يستدعي بين الحين والآخر إعادة النظر في آليات تطبيقه ومآلاته الاجتماعية.
يقوم نظام الميراث الإسلامي على مبادئ رئيسية، مثل التفاضل بين الورثة بحسب القرابة والنوع، وتحديد أنصبة واضحة، وتقديم بعض المستحقين على آخرين، بما يعكس تصوّرًا معينًا للعدالة الاجتماعية في سياق الحقبة التي نزلت فيها الأحكام. ولكن مع تغير طبيعة المجتمعات، وتعقد العلاقات الاقتصادية، وظهور أنماط جديدة للملكية والعمل، أصبح من الضروري التساؤل: هل لا تزال هذه القواعد تلبي متطلبات الإنصاف في واقعنا المعاصر؟
من المهم أن ندرك أن التشريعات لا تنشأ في فراغ، بل تتشكل ضمن سياقات تاريخية واجتماعية معينة. ففي زمن التشريع، كان الاقتصاد يعتمد على الزراعة والرعي، وكان للرجال دور رئيسي في إعالة الأسرة، مما برر تفوق نصيب الذكر على الأنثى في بعض الحالات. لكن مع دخول النساء إلى سوق العمل واستقلالهن ماليًا، أصبح من المشروع التساؤل: هل لا تزال تلك التوزيعات تعكس نفس المعايير التي بُنِيَت عليها؟
على سبيل المثال، قد تؤدي القواعد التقليدية إلى تفاوتات غير مقصودة، خاصة في الحالات التي تكون فيها المرأة هي المعيل الوحيد، أو حينما تتسبب التقسيمات الشرعية في تفتيت الملكيات إلى أجزاء غير قابلة للإدارة الاقتصادية الفعالة، مما يخلق إشكالات في حفظ الثروة واستثمارها.
من المثير للاهتمام أن الفقه السني والشيعي، رغم اختلافهما في بعض تفاصيل التوزيع والولاية على التركة، يتفقان على المبدأ العام الذي يقوم عليه نظام الميراث. ومع ذلك، فإن بعض الفقهاء في كلا المذهبين اجتهدوا عبر العصور في تكييف الأحكام بما يراعي ظروف العصر، سواء من خلال الوصايا، أو بإعمال قواعد التحكيم والتراضي بين الورثة، مما يدل على أن الشريعة، بطبيعتها، تحتمل التأويل والاجتهاد بما يحقق المقاصد العليا للعدالة.
ليس المطلوب هو إلغاء القواعد الموروثة أو تجاوزها، وإنما السعي نحو قراءة مقاصدية تستوعب روح التشريع وتتعامل مع مستجدات الواقع بحكمة. وهذا قد يتحقق من خلال توسيع دائرة الاجتهاد، وتعزيز دور الوصايا، أو حتى استحداث آليات قانونية تنظم التركات بطريقة تراعي العدالة الاجتماعية دون أن تتصادم مع الأصول الشرعية.
إن التفاعل بين النصوص والثقافات المتغيرة أمرٌ لا يمكن إغفاله، فكما تطورت الكثير من الأحكام المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية في ضوء تطورات العصر، فإن من الطبيعي أن يُعاد النظر في كيفية تطبيق قواعد الميراث بطريقة تحقق مقاصد الشرع في تحقيق العدالة، دون أن تُفضي إلى إشكالات اجتماعية غير مقصودة.
لا شك أن نظام الميراث في الإسلام يعكس رؤية تشريعية متكاملة تستند إلى مبادئ العدل والتوازن، لكنه، كأي نظام قانوني، يحتاج إلى تأمل مستمر لضمان أن يظل محققًا للغايات التي شُرِّع لأجلها. إن التوفيق بين النصوص الثابتة والواقع المتغير هو جوهر الفقه الإسلامي، وهو ما يستوجب أن يكون الاجتهاد حاضرًا، والنقاش مفتوحًا، بروح من الانفتاح والموضوعية، حفاظًا على روح العدالة التي كانت دائمًا جوهر الرسالة الإسلامية