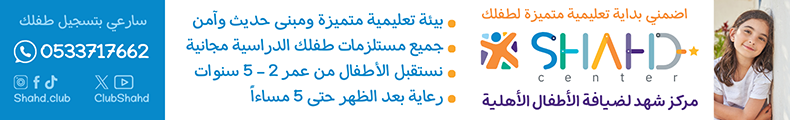القذى
اللسان يحصر دلالة كلمة القذى فيما يصيب العين من الأذى، سواء كان هذا الأذى من الداخل أو الخارج، بحيث يمنع الرؤية السليمة لها، ويزول عند رشقه بالماء، ولكن التاريخ، بما يعنيه من التطور، لا يدع شيئا على حاله، وأعتقد أنه قد حان وقت توسيع دلالة مفردة القذى وليسمح لي ابن منظور أن أضيف إليها مصطلح «القذى النفسي» وهذا القذى يكون من الثبات ومن القوة بحيث لا يستطيع من يعاني منه أن يقاومه أو يزيله، حتى لو غسله بكل ماء البحار.
روى أبو العصماء الأندلسي عن أبيه عن جده قال: «الفرق بين قذى العين وقذى النفس أن الأول يصيب العين عفويا بدون فاعل، أما الثاني فهو يصيب النفس من متعمّد قاصد» أما سبب القصد فلم يذكره جده يا ترى لماذا لم يذكره؟ هل تركه اعتمادا على ذكاء القارئ أم لأنه خاف على من لم يصب به من العدوى بمجرد ذكره؟ تلك أسئلة تولّد أسئلة أصعب منها. مثل «أعلمه الرماية كل يوم / فلما اشتد ساعده رماني» فهذا البيت فيه سؤال مضمر هو لماذا رماني..؟ أحد النقاد شن حملة شعواء عل هذا الشاعر قائلا لم أجد بائسا مثل هذا الشاعر، لماذا وقف مستسلما لمن رماه؟ لماذا لم ينازله، سهما بسهم؟ لماذا لم يقف موقف من قال: «وهبك يميني استأكلت فقطعتها / وشجعت قلبي بعدها فتشجعا» إنه يستحق كل ما أصابه من السهام. هذا الناقد لم يقرأ «ولو كان سهما واحدا لاتقيته / ولكنه سهم وسهم وعاشر» ولم يقرأ ما قالته تلك الأعرابية في ولدها «ربيته وهو مثل الفرخ أعظمه / أمّ الطعام ترى في ريشه الزغبا/ حتى إذا آض كالفحال شذّبه / أبّاره ونفى عن متنه الكربا / أضحى يمزق أثوابي ويضربني / أبعد شيبي يبغي عندي العتبا»
حين أقرأ مثل هذه المواقف في التاريخ، وأرى أن بعضها يقوم بارتكابه أفراد يحملون، «نظريا» قيما نبيلة تناقض سلوكهم، أتذكر ما يسمونه «التنافر المعرفي» وهو ما نراه في سلوك كثير من الناس الذين، إذا نودي للصلاة، نراهم يهرعون للمساجد، رافعين أيديهم بالدعاء للمؤمنين والمؤمنات، فإذ جاءه أحد من دعا لهم ليشتري منهم، غشوه، ماعدا قليلا منهم، والغاش لا فرق بينه وبين السارق. فهل هذه الحالة هي التي يسميها القاموس «الثكل»؟ نعم إنها هي.