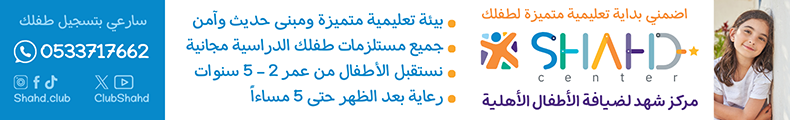التأثير
حين نتخذ من التأثير في الفكر الجمعي مقياسا للفرق بين مفكر وآخر في نفاذ الفكرة واتساعها هل نكون على صواب؟ كلا، هكذا يقول لنا التاريخ والواقع. إن الغزالي كان أوسع تأثيرا من ابن رشد، وحسن البنا أشد تأثيرا من طه حسين، وفى الجانب الوجداني نرى عبدالوهاب البياتي أشد تأثيرا من سعدي يوسف. لماذا يا ترى؟ هل لأن المجتمع لا يحس فرقا بين الضياء والظلام بحيث يصدق عليه قول جلال الدين الرومي «ليس كل عين ترى» أم أن ذلك عائد إلى سبب آخر؟
1. الضياء والظلام المعنويان يراهما الوعي، وكما تتفاوت الرؤية البصرية في البعد والقرب عند الناس، كذلك يختلف الوعي في الرؤى المعنوية.
2. أي إضافة فكرية جديدة إلى ما في وعي الفرد يصطدم بما احتل هذا الوعي من قبل حسب مقولة الفارابي فالثابت فيه يستند إلى قناعة، والقناعة تفضي إلى اليقين الذاتي الذي قد يكون بعيدا عن اليقين العلمي، وهنا يختلف أفراد المجتمع اختلافا واسعا، فهناك قلة نادرة من الأفراد الذين يستطيعون إزاحة ما يتعارض مع الفكر الجديد، أما الأكثرية فتقاومه، مهما كان ساطعا. فكيف إذا تكاثرت عليه الظنون والاحتمالات، واحتاج إلى زمن طويل؛ حتى تنغرس القناعة به في نفوس الناس!
3. إذ أخذنا بأقوال بعض الفلاسفة مثل ديكارت بأن هناك أفكارا فطرية داخل كل فرد، لا يمكن تغييرها، فكيف نوفق بين هذا الرأي وبين إمكانية الجديد فرض نفسه على القديم؟ بالإضافة إلى مقولة العقل الباطن، وأنه المأوى الواسع لكل ما لم يستطع العقل الواعي تحمله. ترى أين يذهب مع الوافد الجديد؟!
4. بطء الزمن الفكري هو ما يجعل بعض الأفكار مستمرا ويجعل منتجيها في الضوء الدائم، وهذا يسبب رسوخ القناعات ودوامها في مجتمعات الأزمان القديمة، وهذا ما يسبب كذلك تكرار أقوالهم. أما الآن فقد كثرت مصادر المعلومات، وأصبح الإنسان نهبا لأعاصير وسيول من الأفكار المتناقضة تفوق قدرته على التحمل مالم يمتلك مقدرة نقدية متوهجة تستطيع التمييز بين الفكر الحقيقي والفكر الزائف.
5. نحن ننسى السؤال عن دافع صاحب الفكر المؤثر، ونسبغ عليه الإضاءة التي يعطيها فكره، وهذا غير صحيح، فالأسباب ليست كلها نبيلة، بل قد يكون بعضها دنيئا، فالتاريخ يحدثنا عن أفراد أثرت أفكارهم في زمنهم، وآخرين لم تفهم أفكارهم المضيئة إلا بعد زمن طويل لدقتها، وكانوا أوغادا.