الوظيفية وأزمة السوسيولوجيا
منذ أن شهد الفكر الاجتماعي بدايته المنهجية في القرن التاسع عشر تنامت النظريات الاجتماعية وتشعبت. لقد أنجبت المادية التاريخية الصراعية المحدثة، وكان ماكس فيبر مع كارل ماركس وضده في الآن نفسه. كان معه في تاريخيته وضده في محتواها المادي، مانحًا أهمية متزايدة للثقافة والقيم. أما وضعية أوغست كونت وأفكار دوركايم فقد أنجبتا البنيوية الوظيفية التي تُعَدُّ من أبرز النظريات السوسيولوجية المعاصرة.
تعود جذور البنيوية الوظيفية إلى نهايات القرن التاسع عشر، وقد كانت البنيوية الأنثروبولوجية مع كلود ليفي ستراوس رافدًا أساسيًّا في تكوين الأساس الإبيستمولوجي للنظرية؛ إذ يفهم المجتمع بصفته كيانًا مستقلًّا عن أفراده. لا تفهم الأجزاء إلا في إطار الكل. غير أن البنيوية لا تتسم بالكلية فحسب، بل هي ترتكز على مفهوم أكثر أهمية هو انحسار الذات، لصالح العلاقة والبناء المتصف بطابعه المتعالي، وما الذات إلا حصيلة عمليات تتجاوزها وتعلو عليها. البنية في ماهيتها نظام يتألف من عناصر مترابطة تتسم بالثبات النسبي، وبما أن للعلاقة بين العناصر أسبقية منطقية على العناصر ذاتها، فسيكون التحليل التزامني أكثر أهمية من التحليل التتابعي، وسيكون هو الأصل في كل عملية تحليلية.
على أن البنيوية الوظيفية لا تعالج البنى وحسب، بل تقرنها بالوظيفة، مقتفية خطى سبنسر ودوركايم؛ إذ «لا بناء من دون وظائف اجتماعية، ولا وظائف اجتماعية من دون بناء»، كما يقول رائد الوظيفية بارسونز. وهي إذ تفعل ذلك فإنها تقيم تناظرًا استعاريًّا بين الجسد والمجتمع، تمامًا كما فعل سبنسر ودوركايم. فالمجتمع جسد يتألف من مكونات مترابطة بنيويًّا ومتساندة وظيفيًّا، على أن يكون هذا النسق متعاليًا فوق إرادة أفراده وتأثيرهم.
شاعت البنيوية الوظيفية بعد الحرب العالمية الثانية، في سياق تاريخي يسوده الصراع بين العالم الرأسمالي والعالم الاشتراكي؛ إذ ينظر إليها بصفتها النظرية السوسيولوجية التي بإمكانها أن تحل محل الماركسية، بوصفها نظرية نقدية تستهدف تفكيك المجتمع الرأسمالي ونقده، في حين شكلت الوظيفية محاولة لفهم هذا المجتمع وتحليل بناه وعملياته وآلياته. وقد بلغت الوظيفية أوجها في منتصف القرن العشرين، وبخاصة مع رائدها الشهير تالكوب بارسونز «1902 - 1979م» إذ زوّد الوظيفية ببناء نظري متناسق، وشكل مدرسة شاعت في أوساط علم الاجتماع.
يعد بارسونز الذي جمع بين الفعل والبنية، محتذيًا دوركايم وماكس فيبر، واحدًا من أصحاب النظريات الكبرى. وصف ذاته بأنه «المريض بداء التنظير»، فلا غرابة أن يكون طموحه المعرفي صياغة نظرية شاملة تستوعب كلية الحياة الاجتماعية، وما علم الاجتماع في تصوره إلا ذلك «العلم الذي يسعى لتطوير نظرية تحليلية لأنساق الفعل الاجتماعي بالاستناد إلى سمة التكامل والإجماع القيمي المشترك».
 إن الفكرة المركزية التي تنتظم حولها البنيوية الوظيفية هي فكرة الاستقرار والنظام، وهي تشكل إجابة شاملة عن سؤال أولي مفاده الكيفية التي يكون بها النظام الاجتماعي ممكنًا: «لماذا يعيش الناس معًا دون أن يحطموا بعضهم؟». هذا السؤال يعيد الذاكرة إلى فكر الفيلسوف البريطاني «هوبز» الذي أقام عليه مفهومه للعقد الاجتماعي، وصاغه بارسونز على نحو تندمج فيه معايير المجتمع مع المعايير ذاتها داخل الفرد، حيث هناك توافق دائم بين قيم الفرد وقيم المجتمع، وهذه الصياغة هي اللبنة الأساسية في سوسيولوجيا بارسونز.
إن الفكرة المركزية التي تنتظم حولها البنيوية الوظيفية هي فكرة الاستقرار والنظام، وهي تشكل إجابة شاملة عن سؤال أولي مفاده الكيفية التي يكون بها النظام الاجتماعي ممكنًا: «لماذا يعيش الناس معًا دون أن يحطموا بعضهم؟». هذا السؤال يعيد الذاكرة إلى فكر الفيلسوف البريطاني «هوبز» الذي أقام عليه مفهومه للعقد الاجتماعي، وصاغه بارسونز على نحو تندمج فيه معايير المجتمع مع المعايير ذاتها داخل الفرد، حيث هناك توافق دائم بين قيم الفرد وقيم المجتمع، وهذه الصياغة هي اللبنة الأساسية في سوسيولوجيا بارسونز.
يتكون المجتمع عند بارسونز من وحدات الفعل الصغرى. ومن مجموع هذه الوحدات يتشكل النسق؛ إذ يرتقي التركيب السوسيولوجي من تحليل وحدات الفعل الصغرى نحو تكوين النسق. والفعل الاجتماعي بنية تتشكل من عناصر الفاعل ذاته والموقف الاجتماعي والقيم الثقافية الموجهة لفعله. لهذا فإن الفعل نسق يضم أنساقًا فرعية تبدأ من العضوي «الحاجات»، ثم الشخصي فالاجتماعي فالثقافي. ويتصاعد التحليل وصولًا للأنساق الرئيسة الماثلة في النسق السياسي والنسق الاقتصادي والنسق الثقافي والنسق الاجتماعي.
المجتمع أنساق، والنسق نمط ثابت من التفاعل؛ ذلك أن أساسه هو الفعل القصدي والنشيط والمبدع، والذي يهدف إلى إشباع حاجة ما؛ إذ يهدف كل فاعل إلى أقصى إشباع ممكن، وعندما يتحقق الإشباع يكون ذلك مدعاة لتكرار الفعل مدفوعًا بتوقع استجابات مماثلة، مؤطرة بمعايير وقواعد وقيم ثقافية تحظى بالإجماع. هذه القواعد الثقافية تشكل ضمانًا لاستمرار تلك الاستجابات، وتعزز توقعات الدور الاجتماعي، وهذا يؤدي إلى تنميط الأدوار الاجتماعية بصفتها حلقة الوصل بين الفاعل والمجتمع، لتشكل انتظامًا سلوكيًّا يدعى نسقًا، على هذا النحو تتطور شبكة من الأدوار المرتبطة بتوقعات سلوكية محددة فتنشأ المؤسسات الاجتماعية الأولية وتتكون منها الأنساق الفرعية والكبرى.
تدخل هذه الأنساق في علاقات ذات طابع وظيفي تساندي. وكل نسق محكوم بشروط وظيفية تتمثل في التكيف والتكامل وإدارة التوتر وتحقيق الأهداف. وسيقود كل تغير في نسق ما، بناءً على هذه العلاقة التساندية التكاملية، إلى تغير في الأنساق الأخرى. إن التغير واقعة تاريخية واجتماعية، لكنه يبدو في فكر بارسونز واقعة إشكالية، فبما أن المجتمع مكون من أنساق ثابتة محكومة بإجماع قيمي ثقافي ويتسم بالثبات والديمومة، فسيكون التغير واقعة استثنائية تعرف بصفتها «تكيفًا تطوريًّا مستمرًّا لمختلف الأنساق المكونة للمجتمع»، ليس التغير سوى تطور داخل البنية، وعليه ستستبعد احتمالات التغير الجذري والثوري الماثل في تغيير البنية ذاتها، وما ذلك إلا بغية التأمين النظري - حتى لا نقول الأيديولوجي - لوظيفة أساسية هي استقرار المجتمع ذاته.
من الواضح أن هناك، في المنظور الوظيفي، ميلًا دائمًا وحتميًّا نحو التوازن بين الأجزاء المكونة للنسق سعيًا نحو تثبيت حالة الاستقرار. وعندما يحدث تفكك اجتماعي ناجم عن أزمة ما، كالتضخم وارتفاع الأسعار مثلًا، فإن على مكونات المجتمع وعناصره التكيف على نحو يعيد الاستقرار والتوازن، من خلال إجراءات تقشفية مثلًا، أو خفض النفقات والأجور. على البنية أن تستقر. والاستقرار يجب أن يكون دائمًا وأبديًّا. ويعتمد تثبيت الاستقرار والتوازن على عمليات التنشئة الاجتماعية التي تؤدي وظيفة إعادة إنتاج الثقافة ونقلها بين الأجيال من جهة، ووسائل الضبط الاجتماعي من جهة أخرى كالقانون وأساليب النبذ العرفي وأجهزة القمع، وهو ما يصبغ الثقافة بطابع المحافظة والديمومة، ويعطل كل احتمالات المشاركة في إعادة بناء الثقافة أو تجديدها.
هكذا نلحظ كيف جعل بارسونز التكامل الوظيفي والإجماع القيمي في قلب نظريته، وهو ما جعلها قاصرة عن فهم وتفسير بعض الظواهر الاجتماعية كالتمرد والصراع، وهو الأمر الذي جعل الأبواب مشرعة أمام تلميذه «روبرت ميرتون» ليطور أفكار أستاذه.
 انتزع ميرتون وهو الذي يعرف بصفته مؤسس الوظيفية الجديدة، الطابع الإطلاقي من النظرية الوظيفية مضفيًا عليها طابعًا نسبيًّا. لقد كان الأستاذ مغاليًا ومتفائلًا وغامضًا، فكان على التلميذ الانخراط في مهمات نقدية، إبستمولوجية وسوسيولوجية. على النظرية أن تقترب من الواقع والحياة. لا بد لها أن تتسم بالواقعية والتواضع. يلزمها التخفف من أعبائها التجريدية بالدنو أكثر من تفاصيل الحياة الاجتماعية؛ لذلك راح ميرتون يستبدل بالنظريات الكبرى ما أسماه نظريات المدى المتوسط، تلك التي تقع بين الفرضيات الأمبيريقية الأقرب إلى الواقع، والنظريات الكبرى التجريدية.
انتزع ميرتون وهو الذي يعرف بصفته مؤسس الوظيفية الجديدة، الطابع الإطلاقي من النظرية الوظيفية مضفيًا عليها طابعًا نسبيًّا. لقد كان الأستاذ مغاليًا ومتفائلًا وغامضًا، فكان على التلميذ الانخراط في مهمات نقدية، إبستمولوجية وسوسيولوجية. على النظرية أن تقترب من الواقع والحياة. لا بد لها أن تتسم بالواقعية والتواضع. يلزمها التخفف من أعبائها التجريدية بالدنو أكثر من تفاصيل الحياة الاجتماعية؛ لذلك راح ميرتون يستبدل بالنظريات الكبرى ما أسماه نظريات المدى المتوسط، تلك التي تقع بين الفرضيات الأمبيريقية الأقرب إلى الواقع، والنظريات الكبرى التجريدية.
إن ميرتون وظيفي، لكن الوظيفة لديه لم تعد أحادية الشكل وبسيطة شأنها عند أستاذه؛ إذ هناك وظيفة ظاهرة مقصودة من البناء الاجتماعي، ووظيفة كامنة غير مقصودة وغير معلنة. لكنه لم يكتفِ بذلك؛ بل نزع عنها صفة الإطلاقية عبر ما أسماه اختلالات وظيفية، حيث يمكن النظر إلى ما هو وظيفي في سياق ما على أنه إعاقة وظيفية في سياق آخر. وبذلك تبدو وظيفية بارسونز ساذجة وقاصرة عن بلوغ واقع الحياة الاجتماعية الأكثر تعقيدًا وتركيبًا وتناقضًا مما تخيل الأستاذ الحالم.
ليس المجتمع بهذه الصورة الحالمة وذلك التجانس كما تزعم سوسيولوجيا بارسونز. ثمة قدر تراجيدي يصيب فئات عديدة من المجتمع. يتوخى المجتمع من أفراده التكيف مع الأدوار التي يرسمها لهم، غير أنه لا يوفر لجميع الأفراد الوسائل ذاتها الكفيلة بتحقيق تلك الأدوار؛ لذلك نرى ميرتون يتوسع في تحليل أنماط التكيف والاستجابات مدخلًا إليها نمط التمرد إلى جانب أنماط الامتثال والانسحاب والطقوسية والابتداع. ونمط التمرد هذا يشكل مدخلًا إلى إعادة الاعتبار للمنظور الصراعي، في خطوة قد تُعَدّ تنازلًا من الوظيفية لصالح النظرية المنافسة. فالفئات المتمردة تشكل تعبيرًا عن تناقضات بنيوية وانكسارات في الإجماع القيمي المزعوم في التصور الوظيفي. المتمرد كائن ساخط لا يتبنى القيم السائدة وحسب؛ بل يسعى إلى تغييرها وقلبها. إنه الثوري الذي يشكل إحراجًا للنظرية. كيف يمكن تفسير هذه الظاهرة دون مساءلة الوظيفية برمتها؟ كيف يمكن فهم ظواهر الصراع والتغير وبالتالي التاريخ دون تحفيز المجهودات النظرية لفتح أبواب السوسيولوجيا على فضاءات جديدة؟
لقد تعرض بارسونز لهجوم شديد من أتباعه قبل خصومه. ليس من ميرتون وحسب، ولكن أيضًا من لدن أسماء بارزة في علم الاجتماع الغربي كألفن غولدنار ورايت ميلز. لحظ ألفن غولدنار أن السوسيولوجيا الغربية تواجه أزمة. رسم ملامحها في كتاب نشره عام 1970م بعنوان: «الأزمة المقبلة لعلم الاجتماع». يفصح الكتاب عن أن هناك اختلاطًا وتداخلًا مربكًا بين النظريات. صار كل شيء مشوهًا بنقيضه. تأثرت وظيفية بارسونز بصراعية كارل ماركس. وفتحت السوسيولوجيا الماركسية في الاتحاد السوفييتي أبوابها على الوظيفية. صارت السوسيولوجيا سديمًا مدوخًا. لم تعد النظرية نقية خالصة.
غير أنّ «رايت ميلز»، وهو عالم اجتماع وصف من بعض دارسيه بأنه «تروتسكي تكساس»، يعيد الأزمة إلى اعتبارات إبيستمولوجية، تمامًا كما فعل ميرتون. الولع بالنظرية جعلها لغوًا، تجريدًا متعاليًا على الواقع، ثرثرة لا تضيف شيئًا. لا بد من ملء البناء النظري بالمضامين الأمبيريقية، لتكون النظرية مفصلة على مقاس الواقع دون أن تشطح بعيدًا في سماء التجريد، كما فعل بارسونز. نقرأ في كتابه «النسق الاجتماعي» نصًّا مُعَبَّأً بكل ما هو غامض وحشو وبديهيات بأسلوب عسير يخفي التحيز الأيديولوجي لصالح الرأسمالية الظافرة في المجتمع الغربي.
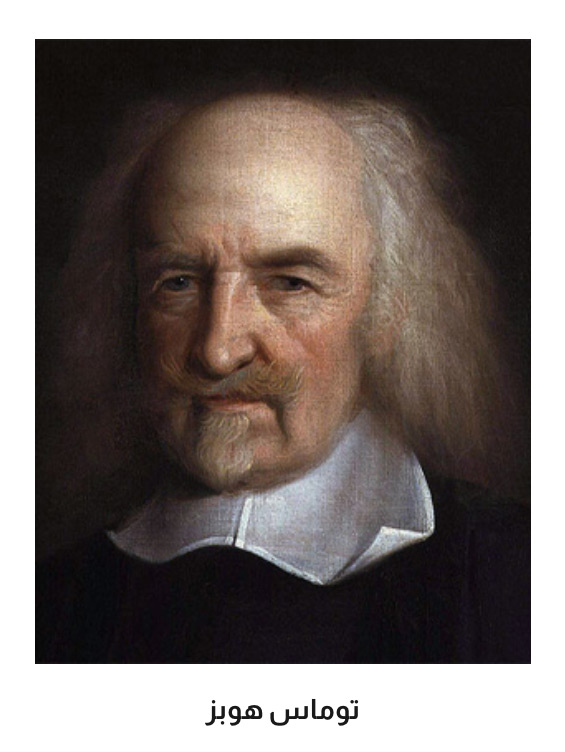 يخبرنا «رايت ميلز» أن الرعب من الماركسية أصاب الوظيفية بالوهن التفسيري وضمور الحس التاريخي. بيد أن إنضاج النظرية مشروط باستحضار ماركس وتاريخية ماركس. التاريخ يمثل مدخلًا منهجيًّا مركزيًّا في كل سوسيولوجيا ممكنة. بتغييب الماركسية يغيب عمق وجوهر السوسيولوجيا ويهمل بعد أساسي في البناء الاجتماعي هو التاريخ والتغير. ليس ثمة سوسيولوجيا ممكنة إلا وهي «ماركسية بالضرورة». لا بد من الإصغاء لماركس لكي نتمكن من بناء مخيلة سوسيولوجية قادرة على الفهم والاقتراب من الواقع. هذا الواقع محك النظرية وفيه تمتحن. الواقع الاجتماعي المعاصر متخم بالمشكلات. ترد الوظيفية المشكلات إلى قيم الأفراد؛ إذ هي ناجمة إما عن عجز في التكيف أو انحراف عن القيم وانتهاك الإجماع القيمي المتخيل. يُفَسَّر الفقر مثلًا بعوامل شخصية؛ الفقراء مسؤولون عن فقرهم. ترد المشكلات دائمًا إلى السيكولوجيا، في حين تردها الماركسية إلى تناقضات بنيوية. فبنى المجتمع هي المسؤولة عن مشكلاته وليس الأفراد، إنها مشكلات بنائية اجتماعية لا نفسية أو شخصية، وعليه فالتغيير مقولة حتمية تقع في صلب الواقع والنظرية، وإهمالها يكشف عن قصور نظري أو انحياز أيديولوجي مسبق ومتعمد.
يخبرنا «رايت ميلز» أن الرعب من الماركسية أصاب الوظيفية بالوهن التفسيري وضمور الحس التاريخي. بيد أن إنضاج النظرية مشروط باستحضار ماركس وتاريخية ماركس. التاريخ يمثل مدخلًا منهجيًّا مركزيًّا في كل سوسيولوجيا ممكنة. بتغييب الماركسية يغيب عمق وجوهر السوسيولوجيا ويهمل بعد أساسي في البناء الاجتماعي هو التاريخ والتغير. ليس ثمة سوسيولوجيا ممكنة إلا وهي «ماركسية بالضرورة». لا بد من الإصغاء لماركس لكي نتمكن من بناء مخيلة سوسيولوجية قادرة على الفهم والاقتراب من الواقع. هذا الواقع محك النظرية وفيه تمتحن. الواقع الاجتماعي المعاصر متخم بالمشكلات. ترد الوظيفية المشكلات إلى قيم الأفراد؛ إذ هي ناجمة إما عن عجز في التكيف أو انحراف عن القيم وانتهاك الإجماع القيمي المتخيل. يُفَسَّر الفقر مثلًا بعوامل شخصية؛ الفقراء مسؤولون عن فقرهم. ترد المشكلات دائمًا إلى السيكولوجيا، في حين تردها الماركسية إلى تناقضات بنيوية. فبنى المجتمع هي المسؤولة عن مشكلاته وليس الأفراد، إنها مشكلات بنائية اجتماعية لا نفسية أو شخصية، وعليه فالتغيير مقولة حتمية تقع في صلب الواقع والنظرية، وإهمالها يكشف عن قصور نظري أو انحياز أيديولوجي مسبق ومتعمد.
هل هو انحياز أيديولوجي لرؤية محافظة؟ هي كذلك في نظر نقادها. فالوظيفية رديف لتشكيل نظري مكون من التوازن والديمومة الأبدية للبنى الاجتماعية والإجماع القيمي والتناغم الرومانسي بين مكونات المجتمع، وبما هي كذلك فهي عضو جديد يضاف إلى جسد السوسيولوجيا المحافظة، منذ أوغست كونت ودوركايم، وهي كذلك رغم هيمنتها ردحًا من الزمن على الخطاب السوسيولوجي في المركز كما في الأطراف، عند المهيمن الرأسمالي كما عند التابع. هيمنة طالت العالم العربي كما يرى السوسيولوجي المصري عبدالباسط عبدالمعطي؛ إذ «العدد الأكبر من المشتغلين بعلم الاجتماع في الوطن العربي ينتمي إلى الاتجاهات المحافظة»، ومن بينها الوظيفية التقليدية التي فقدت هيمنتها ووجاهتها المعرفية، وصارت جسدًا بلا ظلال.














